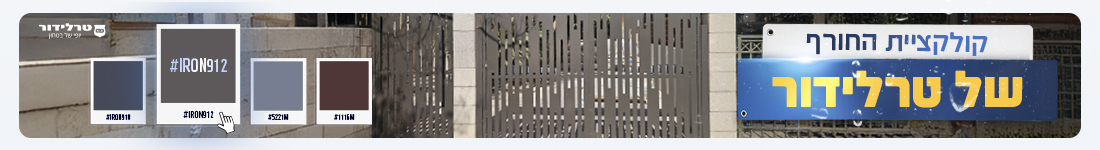هل من المعقول أن تنتهي عداوة دامت أكثر من نصف قرن بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية كوبا وكادت تسبب حرباً عالمية في عهد الرئيس الاميركي جون كينيدي، لمجرد مصافحة تمّت بين باراك أوباما وراؤول كاسترو؟
وهل كانت مصافحة فرضتها المصادفة في لقاء العدوّين يوم تشييع زعيم جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا قبيل نهاية السنة المنصرمة، أم أنها كانت خطّة مدروسة تمّ الاتفاق عليها مسبقاً قبل أن يبادر رئيس الدولة العظمى لمدّ يده الى رئيس الجمهورية الصغيرة؟
الأرجح أنها كانت خطة مدروسة أُعدّت لتنجح بهدف احتواء القلعة الشيوعية العائمة على سطح جزيرة قبالة شاطئ فلوريدا.
هي خطوة أولى في مسافة بحرية لا تبعد أكثر من مئة وخمسة وأربعين كيلومتراً فاصلة بين الإمبراطورية الرأسمالية والجزيرة الفقيرة.
ثمّ أن أوباما يحاول أن يسجلها رقماً في حساب الحزب الديموقراطي استعداداً للانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من العام المقبل، ولطالما نظرت واشنطن الديموقراطية الى كوبا على أنها «دمّل» في خاصرة الولايات المتحدة.
لكن ما حصل حتى الآن لا يبرهن عن عبقرية أوباما، أو عن شجاعته الاستثنائية. ذلك أن شيوعية الجارة الصغيرة لم تعد تشكّل خطراً على أمن الدولة الشاسعة الأطراف، والمدججة بالأساطيل البحرية. ثمّ أنّ كوبا لم تعد تصدّر الى محيطها القريب سوى المهاجرين، وقد بلغ عددهم خلال نصف قرن نحو أربعة ملايين، مخّلفين وراءهم نحو عشرة ملايين من الكوبيين الذين تقطّعت بهم السبل للإبحار شمالاً.
ومع ذلك فقد صمدت كوبا نحو ربع قرن، ولا تزال صامدة حتى اليوم، أمام ترددات الزلزال السياسي الذي ضرب الاتحاد السوفياتي السابق فتساقطت بعده مجموعة الأنظمة الشيوعية في دول أوروبا الشرقية.
ولطالما عاشت كوبا على شعارات التمجيد من قادتها، ومن خطباء وكتّاب وفنانين ورؤساء دول وأحزاب يسارية على مدار العالم. فهي «نجمة الكاريبي» و «قاهرة الأطلسي». وهذا الشعار يعود الى مرحلة الستينات من القرن الماضي، بعد محاصرة «خليج الخنازير»، حيث نصب الاتحاد السوفياتي منظومة صواريخ لحماية نظام «الجزيرة الحمراء». ولم ينتهِ ذلك الحصار إلاّ بعد تفكيك الصواريخ وسحبها الى قواعدها خلف الستار الحديدي.
في تلك المرحلة امتلأت كوبا بوفود الأحزاب الشيوعية من جميع أنحاء العالم، وكانت الوفود العربية مميزة بخطبائها، وقد ألهب أحدهم حماسة الجماهير المحتشدة، فانطلقت الهتافات المدّوية بصوت واحد: تحيا كوبا. يحيا فيديل كاسترو.
ويُروى عن ذلك الخطيب العربي أنه جلس بعد نهاية المهرجان الى مائدة غداء تكريمية، فمال نحوه أحد المسؤولين الكوبيين، وهمس في أذنه وهو يقدّم إليه سيجاراً كوبياً فاخراً: إذا كانت كوبا على هذه الصورة، وأنت تراها بهذا المجد، فما رأيك بأن نتبادل الهويات. أنت تأخذ هويتي الكوبية وأنا آخذ هويتك؟!
كان اسم كوبا إذا لُفظ، أو كُتب، حضر إثنان: فيديل كاسترو وسيجار كوبا. وما كانت هذه الدولة الصغيرة بمساحتها، وعدد سكانها وضآلة ثرواتها، لتكتسب شهرتها لو لم يكن خصمها التاريخي جارها الأميركي الجبّار.
كوبا اليوم دولة متعثرة، وعاجزة اقتصادياً، أكثر من أي مرحلة سابقة. فروسيا كانت تمدّها بالأسلحة وبالتكنولوجيا وفينزويلا في عهد رئيسها السابق الشيوعي هوغو تشافيز وحتى عهد خليفته الحالي (مادورا) كانت تمدّها بالنفط وبتمويل بعض مشاريعها الضرورية. لكن مع تدهور أسعار النفط أصبحت فينزويلا عاجزة عن تمويل مشاريعها بعدما تراجعت مداخيلها بنسب هائلة وارتفعت أسعار مستورداتها بمعدلات عالية، فيما عمّت البطالة والركود الاقتصادي، وانتشرت الفوضى والجرائم.
هذا الواقع الضاغط في المحيط الكاريبي شجّع إدارة أوباما على الاقتراب من الجزيرة المربكة بأزماتها الاقتصادية، وبعجز ماليتها، وجاءت الفرصة السانحة لمدّ اليد الى الجار الشيوعي الذي صافح، لكنه حذّر الجار الجبّار من محاولة التدّخل في شؤون دولته ونظامه.
هذا من ضرورات الشكليات التي، على بساطتها، تولّد أملاً لدى الكوبيين بالاتجاه شمالاً. لكن إذا ما تيّسر لهم دخول «الجنّة» الأميركية من الباب الشرعي فقد يجدون ترحيباً من الأميركيين الأصليين، لكنهم لن يجدوا مثل هذا الترحيب من مواطنيهم الكوبيين الذين سبقوهم بالعبور قبل عقود من الزمن. فهؤلاء الكوبيون القدامى المتأمركون غاضبون على أوباما الى حدّ وصمه بالخيانة، لأنه صافح عدّوهم راوول كاسترو شقيق السلف الأكبر فيديل كاسترو، صانع معجزة صمود كوبا الشيوعية منذ أكثر من نصف قرن. وهذا لا يعني أن كوبا سوف تغطس في مياه الأطلسي الأميركي لتغتسل من صبغة الشيوعية ثمّ تخرج بحلّة ديموقراطية. هذا رهان صعب، إنما غير مستحيل. فكوبا تستعد لشدّ الرحال شمالاً.
كل ذلك من التفاصيل، وليس من الأسباب والعوامل التي تراكمت وسبقت سقوط الإتحاد السوفياتي، وبعده دول الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، وصولاً الى جمهورية كوبا التي لا تزال صامدة.
لكن هناك دوراً لقوة فاعلة تقف خلف ستار شفاف وترافق التغيير الذي بدأ عند جدار برلين منذ عام 1990. إنه دور للفاتيكان بدأه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، ويتابعه البابا الحالي فرنسيس.
البابا الأول أتى من جذور بولندية، وقد تعاطف مع ثورة بلاده على النظام الشيوعي ونجح. والبابا الحالي من الأرجنتين إحدى أكبر الدول وأعرقها في أميركا اللاتينية، ومعظم شعوبها تعتنق الديانة الكاثوليكية. والأديان في هذه الوصلة من العصر الحديث إحدى القوى الفاعلة في توجيه مسار الشعوب. والبابا فرنسيس لا يخفي عطفه على كوبا.
ويبقى سؤال: هل تنتهي الشيوعية كنظام دولة وشعب في هذه الحقبة من الزمن؟
بعد كوبا لا دولة شيوعية. ذلك أن الصين لم تعد شيوعية إلا بالاسم. صحيح أن نظامها صارم، لكنه نظام قومي يستند الى ثقافة عريقة تتمثّل بطاعة الحاكم، كما اليابان، مع الفارق بين الإمبراطورية اليابانية والإمبراطورية الصينية.
ثمّ أن الدولتين العظميين تمسكان في هذا العصر بكتلة جبّارة من شرايين الاقتصاد والثروات الصناعية والمالية في العالم، فضلاً عن ثروة التكنولوجيا التي وُلدت في الغرب ونمــت وازدهرت في اليابان والصين.
أمّا اليسار بمعنى الحرية والديموقراطية والمساواة والسلام، فلا بدّ أن يستمر غاية الشعوب التي تستطيع أن تمضي في اتجاهه لعلها تبلغه، وليس في المدى المنظور موعد مع هذا الوعد. لكن التاريخ سيحفظ للرئيس الأميركي باراك أوباما أن عهده كان الشريك الأكبر في نكبة العالم العربي حمايةً لإسرائيل، وضمان تفوقها واستقرارها.
________________________
* كاتب وصحافي لبناني