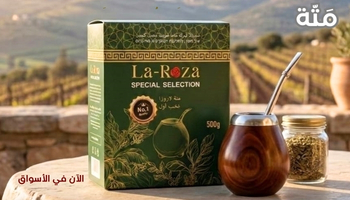كنت في اسطنبول حين اختار رجب طيب أردوغان منبر الأمم المتحدة لمهاجمة ما يعتبره حكماً انقلابياً في مصر. ذهب الرجل أبعد من ذلك حين ارتكب هفوة ديبلوماسية لا يجوز لرئيس دولة بحجم تركيا أن يرتكبها بحق رئيس دولة بحجم مصر. ولم تتأخر آثار الهفوة في الظهور على الشاشات والصفحات. أضاف أردوغان جرحاً جديداً إلى العلاقات التركية – المصرية المثخنة بالجروح.
لم أتوقع أبداً أن يكون أردوغان ودوداً في الحديث عن مصر الحالية وزعيمها، لكنني لم أتوقع أن يصبّ الزيت على النار فيما تنشغل المنطقة بارتكابات «داعش» وضربات التحالف ونزوح الأكراد. إنه أسلوب أردوغان المباشر والحادّ والاستفزازي. إنه يصرّ الآن على إسقاط «ديكتاتور دمشق» بعدما كان يسميه على مدى سنوات «صديقي بشار».
لصديقي التركي تفسير يستحق التسجيل. قال إن أردوغان حماسي وانفعالي. سبق أن أدخل السجن لإلقائه قصيدة حملت شحنة عالية من التحريض. ثم إنه يكره الجنرالات لأنهم أعاقوا وصول الإسلاميين إلى السلطة في أنقرة وأرغموهم بعد وصولهم على الرقص في ظل دستور علماني. يكره أيضاً حرص الجنرالات على الظهور في صورة حراس الجمهورية والعلمانية.
أضاف أن ما حصل في مصر في 30 حزيران (يونيو) 2013، ترك جرحاً عميقاً لدى أردوغان. ازدادت وطأة الجرح حين نجح حكم السيسي في تفادي العزلة الدولية، خصوصاً في أوروبا وأميركا والدليل لقاء السيسي وباراك أوباما في نيويورك. دور السعودية كان قاطعاً وحاسماً في منع محاصرة النظام الجديد في مصر، ومساعدتها السياسية لا تقل أهمية عن مساعدتها الاقتصادية.
قال الرجل إن المشهد كان مختلفاً بالتأكيد لو كان محمد مرسي لا يزال رئيساً لمصر. كان موقع أردوغان مختلفاً في نادي الأربعة الكبار في الإقليم وهي تركيا ومصر والسعودية وإيران. كان ثقله في الإقليم مختلفاً، خصوصاً في المرحلة الحالية. كان باستطاعته مخاطبة أميركا وأوروبا من موقع مختلف. اليوم يجد نفسه أمام علاقة سعودية – مصرية مميزة قد تكون قادرة على عرقلة الطموحات التركية والأحلام الإيرانية أو الاعتراض عليها.
وأردف أن ما فعله السيسي أنه حول «الربيع العربي» من فرصة تاريخية لـ «الإخوان» إلى نكبة تاريخية لهم. لو نجحت تجربة مرسي لكانت المنطقة تعيش في ظل مرشد في القاهرة ومرشد في طهران، وثمة من يعتقد أن أردوغان كان سيتحول إلى مرشد للمرشد المصري.
غادرت اسطنبول إلى بيروت. أمضيت يومين في جمهورية الرأس المقطوع، ثم غادرت إلى القاهرة.
تذكرت يوم زرت مصر في حزيران 2013 قبل أيام من الانتفاضة التي جرحت أردوغان وأربكت أحلامه وحساباته. في تلك الأيام كانت رائحة التوتر تنذر بمقدمات حرب أهلية. سمعت من محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي أن مصر «خائفة على روحها وهويتها»، وأن المصريين يستعدون لاستعادة ثورتهم من قبضة «الإخوان». كانت مصر جريحة وقلقة تشبه مركباً تتقاذفه الرياح.
في 30 حزيران تدفق ملايين المصريين في الشوارع. كان عبدالفتاح السيسي على موعد مع قدره. التقط الرسالة وذهب إلى الموعد.
كم تبدو المسافة بعيدة بين مصر التي رأيتها قبل أيام ومصر التي عاينتها في حزيران 2013. لا أقصد أبداً الإيحاء بأن مصر حلّت مشاكلها الكثيرة والكبيرة. أقصد أن الزائر يشعر بأن الدولة تعمل والمؤسسات تعمل، وبأن السيسي احتفظ بالقدرة على الاتصال بالمصري العادي الذي ترجم انخراطه في الورشة المفتوحة عبر المساهمة في قناة السويس الجديدة ومشاريع أخرى.
أهم ما تحقق حتى الآن هو نجاح السيسي في إطلاق حالة من الأمل لدى المصريين، وإطلاق حالة من الشراكة بين الرئيس والمواطن العادي. سمعت من محبين لجمال عبدالناصر أن شعبية السيسي تفوق شعبيته. ليس المطلوب وجود عبدالناصر آخر. المراحل التاريخية لا تتكرر. ومصر تحتاج إلى مشروع عصري للاستقرار والازدهار واستعادة موقعها الريادي وإشعاعها الثقافي.
كنا في عشاء سياسي وثقافي. غادر الوزير قبل منتصف الليل. شرح لي الحاضرون أن الوزراء يحضرون إلى مكاتبهم باكراً. فالسيسي قد يتصل بالوزير في السابعة صباحاً. يراقب ويواكب ويستعجل إنجاز المشاريع قبل المواعيد المقررة.
في القاهرة فهمت سبب غضب أردوغان. وعمق جرحه المصري. كان على «إخوان» مصر أن يضبطوا شهياتهم أمام وليمة السلطة. وكان على أردوغان أن يخفي قليلاً أوجاع جرحه المصري.