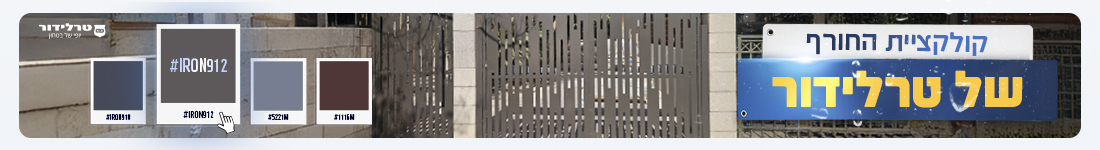على مدى العقد الماضي، كانت الحكومة الروسية من أكثر المتمسكين بكتلة «بريكس» الاقتصادية، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويوم وصل الرئيس المصري السابق محمد مرسي الى الحكم، أعلن نية بلاده الانضمام الى هذه الكتلة، وكذلك فعلت تركيا التي حاولت التقرب من الكتلة ذاتها كبديل من الاقتصاد العالمي، القائم على تفوق الغرب بزعامة الولايات المتحدة.
واعتقدت موسكو لوهلة إمكان أن تتزعم هذه الكتلة لاستعادة سيادتها في وجه غريمتها أميركا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأسيس مصرف خاص لـ«بريكس» برأس مال 50 بليون دولار، وعدت روسيا بتقديمه قبل دخولها في مواجهة مع الغرب وتعرّضها لعقوبات، أدت إلى انهيار ثلثي قيمة عملتها الوطنية، ما اضطرها للاستعانة بفائضها المالي الذي تراجع من 524 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، إلى أقل من 20 بليوناً مع نهاية العام الماضي، استناداً إلى التقارير الأميركية، بسبب انخفاض سعر النفط العالمي واضطرار روسيا إلى الدفاع عن عملتها بسبب العقوبات.
ويبدو أن روسيا تعلّمت درساً اقتصادياً مفاده بأن «بريكس» كتلة وهمية غير موجودة فعلياً، وهي مجرد تسمية أطلقها أحد الخبراء الأميركيين. وظهرت ذروة عدم تماسك هذه الكتلة، عندما زار بوتين الصين في محاولة لتأسيس ما يشبه الاتحاد الاقتصادي، وبيع الطاقة الروسية الغزيرة إلى السوق الصينية العطشى. لكن الصينيين لم يبدوا حماساً لعروض بوتين، وقدموا له أسعاراً بخسة ثمن الطاقة الروسية.
وبعد فشله في تزعم كتلة تجمعه مع الصين، حاول بوتين إعادة احياء الكتلة الشرقية، على الأقل مع الجمهوريات السوفياتية السابقة حتى لو من دون دول أوروبا الشرقية. لكن الغرب مثل الاتحاد الأوروبي، قدم عروضاً أفضل لهذه الجمهوريات، مثل أوكرانيا وسلوفينيا وحتى جورجيا، ما أفضى إلى مواجهات سياسية داخل هذه الدول بين فريق موالٍ لموسكو وآخر معارض لها ويتلقى دعماً غربياً، فانهارت حكومة كييف، واحتلت القوات الروسية شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وفرض الغرب عقوبات على موسكو.
وتزامنت العقوبات مع توقيع شركة «أكسون» الأميركية للطاقة عقداً ضخماً مع شركة «روزنفت» للطاقة التابعة للحكومة الروسية، وهي شراكة تسمح للاثنين بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في أراض روسية، تبلغ مساحتها 630 ألف كيلومتر مربع (نحو مساحة فرنسا). ويقع معظم الأراضي في مناطق مجاورة للقطب الشمالي، وكانت متجمدة حتى الأمس القريب، إلى أن أفضى الاحتباس الحراري إلى انكشاف أجزاء كبيرة منها. فعرض الأميركيون تقنيتهم المتفوقة في استخراج النفط فيها، ووافق الروس. وقدمت «إكسون» نصف تريليون دولار للروس، وهو ما يوازي نصف الناتج المحلي الروسي.
إلا أن العقوبات الأميركية جمّدت صفقة «إكسون» مع روسيا، إلى أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وعيّن المدير التنفيذي السابق لـ «إكسون»، ريكس تيلرسون، الحائز من بوتين على وسام «صديق الأمة الروسية»، وزيراً للخارجية. ويتوقع الخبراء أن يسعى ترامب وتيلرسون إلى رفع العقوبات الأميركية عن روسيا على وجه السرعة، واستئناف الشراكة المرسومة سلفاً.
هكذا وجدت موسكو ضالتها الاقتصادية، فهي بدلاً من البحث عن شركاء لمنافسة أميركا والغرب، ستدخل مع أميركا والغرب في كتلة اقتصادية تواجه فيها الصين وبقية العالم.
ويشير خبراء الى ان هذه الخطة الجيواستراتيجية، هي من تصميم وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسينجر، وهو نفسه سبق ان عمل مهندساً للانفتاح الأميركي على الصين في سبعينات القرن الماضي، بهدف مواجهة روسيا. واليوم، يهندس كيسينجر انفتاحاً اميركياً على روسيا لمواجهة الصين.
والتحالف الأميركي – الروسي يداعب مخيلة القاعدة الشعبية لترامب، خصوصاً من الأميركيين الذين دأبوا على مدى العقدين الماضيين، على التحذير من صعود بقية العالم اقتصادياً في وجه الغرب. هذه المرة، سيشكل الغرب كتلة تتفوق على بقية العالم. لهذا السبب، حرص ترامب على القضاء على «اتفاق الشراكة عبر الهادئ»، وهو يسعى اليوم إلى استبدالها بشراكة مع موسكو وأوروبا. وأوروبا هذه ستكون جديدة ومختلفة عن الاتحاد الأوروبي.
وإذا كتب لخطة ترامب – بوتين النجاح، فإن كتلة اقتصادية مؤلفة من أميركا الشمالية وأوروبا وروسيا وربما استراليا، ستشكل أكثر من 40 تريليون دولار في حجم اقتصادها، أي 57 في المئة من الاقتصاد العالمي، مقارنة بـ 40 في المئة كانت ستشكلها كتلة «الشراكة عبر الهادئ».
ويسعى مهندسو الكتلة الاقتصادية الجديدة الى عزل بقية العالم من طريق وقف الهجرة ومنع رأس مالها من الاستثمار في الكتلة المنافسة، وفرض حمايات جمركية، أي سيكون الغرب الجديد بمشاركة روسيا، كتلة اقتصادية مغلقة، شبيهة الى حد ما بالاقتصاد الفرنسي، وهو ما كان يسعى بوتين إلى إقامته بالاشتراك مع الجمهوريات السوفياتية السابقة.