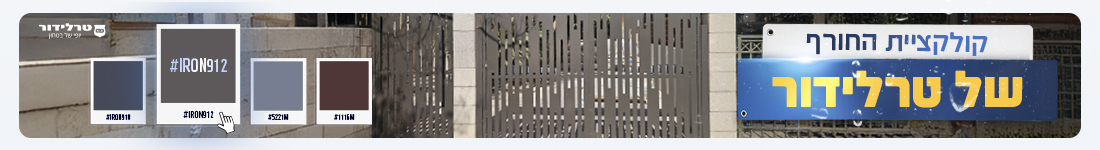الوثائقي “روشميا”.. الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان دبي السينمائي
الخلط ما بين الوثائقي والروائي، والتعامل مع السينما كفن سينمائي من دون تصنيف العمل على أنه وثائقي أو روائي، كانت ولاتزال، رغبة تستحوذ على مسعود أمر الله المخرج والمدير الفني لمهرجان دبي السينمائي. لسنوات ظلّ يتحدث في هذا الأمر، فقد كان يشعر بوجود انتقاص ما للفيلم الوثائقي، سواء في الرؤية والمشاهدة، أو في النظرة إليه التي تعتبره أقل درجة من الروائي مما كان يجعل جمهور الوثائقي دائما محدود وربما غائب عن شاشاته. نجح أمر الله في تطبيق فكرته في مهرجان الخليج السينمائي، جعل المسابقة للفيلم الطويل بشكل عام فدخل الجميع إلى القاعة السينمائية وشاهد الفيلم الوثائقي وصارت التجربة بشكل جيد، لكن ظل الأمر بعيدا عن التجريب في مهرجان دبي إلى أن واتته الجرأة في الدورة الحادية عشرة (10- 17 ديسمبر 2014 ) لاختبار هذا الحلم.
ثمانية أفلام وثائقية – من بين سبعة عشر فيلما سينمائياً شاركت في مسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي هذا العام – استحوذ اثنين منها على ثلثي جوائز مسابقة المهر الطويل – “سماء قريبة” لنجوم الغانم حصد جائزة أفضل فيلم غير روائي، و”روشميا” للمخرج ابن الجولان السوري المحتل سليم أبو جبل استحق جائزة لجنة التحكيم والذي سنخصص له مقالنا هذا، بينما نال الثالث – “المجلس” للمخرج الأردني يحيي العبد الله – شهادة تقدير.

روشميا
ينتمي “روشميا” الشريط الوثائقي الطويل، 70 دقيقة للمخرج سليم أبو جبل للإنتاج المشترك فهو فلسطيني إماراتي قطري سوري، كما أن تتر الختام يُشير إلى وجود فريق كبير ممن ساهم في دعمه وتطويره، من بينهم برنامج إنجاز، مؤسسة الدوحة، ودبي فيلم ماركت، وكل من مؤسسة الشاشة بيروت وصندوق آفاق، إلى جانب فريق عمل آخر في برلين. كذلك تمت مرحلة المونتاج النهائية بالقاهرة داخل بلاتوه 84، دون أن ننسى دور ريتشيل ليا جونز كمستشارة للسيناريو.
أمور عدة لافتة في تجربة فيلم “روشميا”، ليس فقط على مستوى جمالياته البصرية والسردية وما غلفّها من شاعرية ولحظات الذروة غير المتوقعة، أو حتى إيقاعه شديد الخصوصية الموسوم بالهدوء حدّ السكون، لكن أيضاً على مستوى التجربة الإنتاجية فقد جاء متشبعاً بروح الجماعة والأخذ برأي الآخر رغم أن مخرجه لعب أدواراً كثيراً فيه بدءاً من التصوير الذي كان مدرسة نجح أثناءها في تطوير نفسه، مروراً بكتابة السيناريو النهائي له ووصولاً إلى المونتاج الذي تعلّمه على مدار أربع سنوات ليقوم بنفسه بتلك العملية.
“روشميا” هو الوادي المنسي في أطراف مدينة حيفا ومن الصعب أن يعرفه أحد أو أن يراه لأن المدخل إليه من جهة البحر والوصول إليه ليس سهلاً، لكن المخرج وصل إليه وتضامن مع شخصياته: أبو العبد وزوجته أم سليمان، وكان ضمن حملة إعلامية شارك فيها لأجل المساندة في حل مشكلتهما وتسليط الضوء عليها، لكنه لم يكتفِ بهذا الدور أو بالتقرير الصحفي الذي كتبه عن مأزقهما، فقد ظلّ على تواصله معهما إنسانياً عن طريق التواجد بشكل يومي لمعايشة ظروفهما ومعرفة أدق تفاصيل حياتهما اليومية وما يصير بينهما من جدل أو نقاش أو سخرية، تماماً مثلما تحمّل بصبر، يُحسد عليه، لحظات الصمت الطويلة المثقلة في انتظار ردود أفعالهم المتباينة والتي نادراً ما تحمل جديداً.
يرصد الشريط حياة يوسف حسان – أبو العبد – الشخصية الرئيسية في الفيلم، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يعيش في براكية – أي بيت من الصفيح – منذ عام 1956 بعد لجوئه من حي وادي الصليب إثر نكبة عام 1948 مع زوجته آمنة اللاجئة هي أيضًا من قرية ياسور. هناك تسير الحياة، التي تبدو وكأنها متأخرة مائة عام عن الزمن الحاضر، بشكل شبه طبيعي في الوادي رغم أن بلدية حيفا لا تقدم لسكانها أية خدمات، فيعيشان من دون ماء أو كهرباء أو شبكة هاتف وكأن البلدية لا تعترف بهما. بيت الرجل وزوجته يحيط به جدران الوادي من الجهتين وكأن هذه البراكية القابعة في قعر الوادي تحمل دلالة رمزية موجعة وكأنها قعر العالم الذي أصبح المكان والمأوى الوحيد للفقراء.
تظل الأمور سائرة على منوالها في الوادي المهجور منذ بداية ثمانينات القرن الماضي حين كان وادي روشميا منطقة مأهولة إلى أن هجره الجميع باستثناء يوسف حسان وزوجته اللذان أصرّا على البقاء ورفضا الخروج رغم انعدام سبل المعيشة، مفضلِّين مواصلة الحياة في تلك البقعة المعزولة عن الحضارة الحديثة وكأن الخروج منها هو معادل معنوي للموت. ويستمر الحال إلى أن تُقرِّر بلدية حيفا إقامة نفق يمر عبر وادي روشميا لكي يربط أحياء البحر الأبيض المتوسط بأحياء “جبل الكرمل”، وهو الأمر الذي يعنى هدم كوخ أبو عبد وزوجته بالقوة، ومن ثم كان عليهما البحث عن منزل جديد يأويهما.

أثناء ذلك يظهر عوني، الشخص الذى يرعاهما، ويتكفل بالبحث المستمر للحصول على تعويضات من البلدية، لكن وجوده يُذكرنا بأسلوب هنريك إبسن إذ تبدو أمور العائلة بخير وعلى ما يرام إلى أن يدخل إليها الغريب فيتكشف عكس ما يظهر لنا وتنقلب الأمور رأساً على عقب، وهو ما يتأكد في الثلث الأخير من الفيلم الذي يكشف عن ذروة درامية مؤلمة وشديدة التعقيد – يصعب على عمل روائي، إلا فيما ندر، أن يُصيغ حبكتها بكل هذا الصدق وردود الفعل التلقائية المشحونة بالانفعالات المتباينة- عندما يسود التوتر والشجار بين الثلاثة، خصوصا بين الزوجين، وكأن الخروج من البيت ليس فقط – في نظر أبو العبد – معادل للموت ولكن أيضاً كأنه إعلان وفاة لتلك العلاقة الزوجية، إذا لا تصمد أمام تلك العاصفة، فبينما لا تتضايق أم سليمان من فكرة الخروج وهدم البيت إذ يكون كل ما يشغلها أن تأخذ نصيبها من الأموال وتتصرّف هي فيه كما تشاء وتستقل بحياتها، نجد على العكس منها أبو العبد يظل ثابتا على مبدئه ومخلصاً له، فهو يرفض الخروج مثلما لا تشغله أموال التعويضات معلنا أنه ليس بحاجة إليها ولا يريدها، وكل ما يحتاجه فقط هو أن يتركوه يُكمل بقية أيامه وحياته في بيته هذا المصنوع من الصفيح، وهو ما تُؤكده دموعه في الدقائق الأخيرة وتلك اللقطات التي تسجل توديعه لكل شجرة في أرض بيته، ثم ملامحه التي يعتصرها الحزن والحسرة في لحظة هدم البيت.
ظل سليم أبو جبل يرصد بكاميرته عشرات الساعات على مدى شهور. كان يصوِّر أكثر من عشر ساعات يوميًا، ينتظر وينتظر ويسأل ويستمع إليهم، يصمت ويصبر على حكيهم القليل وربما الشحيح. التكرار في الحياة اليومية أتاح له فرصة أن يأخذ الأفعال نفسها من زوايا عدة فيبدو التصوير وكأنه قد تم بثلاث كاميرات وليس بكاميرا واحدة. وإن كانت حركة الكاميرا ثابتة في أحيان كثيرة أو حرة في بعض المرات القليلة لكن المؤكد أن الكوادر وتكوينها جاء كلوحة تشكيلية مرسومة بجهد وتأنِّ من أجل التعبير عن حياة الشخصيات المسنة وهى في حالة صراع البقاء مقابل أنفسها ومقابل البلدية التي تُهدِّد بقاءها.
بعد كل هذا الكم من التصوير كان لابد من رحلة أخرى لا تقل عناءً تتجسد في الاختيار وبناء السيناريو من بين هذا الكم الهائل من المواد المصورة، ويقول سليم أبو جبل أنه خلال المونتاج كان يجد بعض المشاهد ساحرة فيُبقى عليها، بينما كانت بعض المشاهد تفقد سحرها فيلجأ إلى حذفها والاستغناء عنها، مثلما استغنى تماماً عن الموسيقى المباشرة واكتفى بالتسجيلات الصوتية الطبيعية من وحي المكان واستعان أحيانا بصوت الراديو.
نجح سليم أبو جبل في تجربته الفيلمية الأولى ومن خلال ضبط الزمن النفسي للقطات واضعاً في اعتباره الإحساس بهذا الزمن وهو يربط كل لقطة مع ما قبلها وما بعدها من لقطات يملؤها الصمت، نجح في خلق هذا الإيقاع الشاعري المرهف المعبر بصدق عن إحساس وعوالم شخصياته.