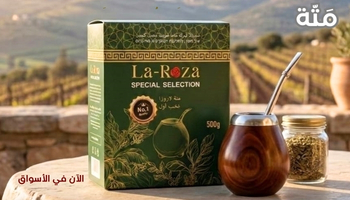لم يكن لكل هذا الحراك السياسي الإقليمي والدولي بشأن القضية الفلسطينية أن ينهض لو لم يكن هناك فعل سياسي وشعبي فلسطيني عارم في مواجهة الاحتلال.
عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام مؤتمر “إيباك” في واشنطن، الأولويات التي تتصدر اهتمامات الحكومة الإسرائيلية، وكان الملف النووي الإيراني في صدارة هذه الاهتمامات، تلته الأزمة السورية وتداعياتها، في حين كان الموضوع الفلسطيني وعملية التسوية المطروحة النقطة الأخيرة على سلم اهتمامات حكومة نتنياهو.
وإذا كان صحيحا أن كلا من الملف الإيراني والأزمة السورية، قضيتان كبيرتان ينشغل بهما المجتمع الدولي منذ وقت ليس بالقصير، إلا أن تراجع الموضوع الفلسطيني إلى المرتبة الثالثة من انشغالات تل أبيب لا يعود بالأساس إلى عدم أهمية القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا، بل لأن هذه القضية لا تشكل قلقا لحكومة نتنياهو التي تعتبر أنها قطعت شوطا كبيرا في تأطير البحث في سبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى درجة أن نتنياهو لم يجد في واشنطن مؤخرا سوى مطالبة المفاوض الفلسطيني بالاعتراف بيهودية إسرائيل كشرط لازم للمضي قدما في التسوية.
في عام 2000 والسنوات القليلة الذي تلته، كان الشغل الشاغل للحكومات الإسرائيلية وبخاصة حكومة شارون، هو محاولة زج فعاليات انتفاضة الاستقلال التي اشتعلت في الضفة وغزة في قاموس الإرهاب الذي كثر استخدامه على الصعيد الدولي بعيد تفجيرات واشنطن ونيويورك في أيلول /سبتمبر من عام 2001.
حتى واشنطن التي كانت منشغلة في تشكيل ما سمي “الجبهة العالمية لمكافحة الإرهاب” لم تستطع أن تقفز عن القضية الفلسطينية في معرض تحشيدها لدول المنطقة في هذه الجبهة، فواظبت على تكرار القول بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في تلك الفترة كانت فعاليات الانتفاضة بأشكالها المختلفة تقلق الاحتلال الإسرائيلي، وانعكس هذا القلق على الخارطة الحزبية والسياسية في المشهد الإسرائيلي بشكل واضح.
وفيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يودع ولايته الحكومية في نهاية عام 2000 على وقع اندحار الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانفجار اجتماعات “كامب ديفيد2” في صيف عام 2000، فإن أريئيل شارون الذي تقلد رئاسة الوزراء بعده وجد نفسه وجهاً لوجه أمام الانتفاضة العارمة التي اشتعلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في تلك السنوات، فرض الواقع الفلسطيني نفسه على الإدارة الأميركية وهي في معرض بلورة خطة “خارطة الطريق” فأفردت لمسألة البؤر الاستيطانية وضرورة تفكيكها حيزاً مهماً ومحدداً في الخطة.
وعلى الرغم من الملاحظات الجوهرية الكثيرة التي طرحت على “خارطة الطريق” إلا أنها تحدثت بوضوح عن إزالة الاحتلال وقيام دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي دفع شارون للمناورة وتقديم شروطه الاعتراضية الأربعة عشر في مواجهة الخطة الأميركية.
وانعكس الفعل السياسي والشعبي الفلسطيني في ظل الانتفاضة على الدور العربي الرسمي الذي رسم في قمة بيروت العام 2002 المبادرة السعودية تحت عنوان “المبادرة العربية للسلام” وكان الموضوع الفلسطيني وسبل حل الصراع مع إسرائيل الشغل الشاغل لعدد من القمم العربية المتتالية، ونشأت على خلفية ذلك لجنة المتابعة العربية لتنضم إلى جهد “الرباعية الدولية” بعد ترسيم خطة خارطة الطريق على المستوى الدولي.
باختصار، لم يكن لكل هذا الحراك السياسي الإقليمي والدولي أن ينهض لو لم يكن هناك فعل سياسي وشعبي فلسطيني عارم في مواجهة الاحتلال.
في السياق ذاته، يمكن القول إن انحسار الاهتمام الدولي والإقليمي بالموضوع الفلسطيني كان يترافق مع تراجعات جوهرية على المستوى الفلسطيني الداخلي سياسيا وتنظيميا.
فلقد انجذبت قيادة السلطة ومنظمة التحرير نحو خطة “خارطة الطريق” كما هي دون أن تقرأها بميزان الحقوق الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولم تطرح في مواجهتها محددات تضع واشنطن أمام ضرورة العمل الجدي باتجاه تسوية متوازنة وشاملة، في الوقت الذي استطاع فيه شارون أن يحمل الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على التراجع عن وصف جدار الفصل العنصري بالأفعى الملتوية على الأرض.
وتمكن مع مرور الوقت من الحصول على ضمانات من الإدارة الأميركية بأن يأخذ أي حل مطروح بالاعتبار التغيرات التي وقعت في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس منذ أن وقع الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967.
هذا الانجذاب “الرسمي” الفلسطيني نحو الخطة الأميركية جاء على حساب الانتفاضة وأهدافها في الحرية والاستقلال.
من جانب ذي صلة، تعرضت الأوضاع الفلسطينية الداخلية إلى نكسات متتالية منذ وقع الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ووقع التناحر الفئوي والجبهوي ليصل ذروته الدامية في الانقسام المدمر الذي وضع الحالة الفلسطينية في حالة من التردي انعكست فعليا على الصدى الإقليمي والدولي للحقوق الوطنية الفلسطينية.
هذه الأيام، يتكرر للأسف السيناريو نفسه، والمتغير الوحيد هو مرور الوقت على حساب الفلسطينيين في الوقت الذي يتغول فيه الاستيطان.
والموقف السلبي من الخطة الأميركية السابقة، لا يزال يلوح حتى اليوم تجاه ما يسمى “إطار كيري” الذي جاء على قياس الشروط الأمنية والتوسعية الإسرائيلية.
وكان الدخول في المفاوضات الحالية على حساب المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة الذي اشترط الوزير الأميركي كيري على المفاوض الفلسطيني إيقاف هذا المسعى كي يفتح أمامه قاعة المفاوضات..وللأسف وافق.
لقد وضع هذا الموقف الحالة الفلسطينية في حالة من المراوحة ووجدت نفسها مجددا أسيرة الشروط الأمنية والتوسعية الإسرائيلية بموازاة الانحياز الأميركي الفاضح لهذه الشروط.ونزع بالتالي أهم الأسلحة التي وفرها الانجاز الفلسطيني في الأمم المتحدة والذي كان من المفترض أن يتم البناء عليه بالتوجه مباشرة مرة أخرى نحو الأمم المتحدة وتقديم طلبات انتساب دولة فلسطين إلى المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة تلك المعنية بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ومكن هذا الموقف الاحتلال وحكومته من التمتع بوقت اضافي خال من أية مواجهة سياسية أو ميدانية تضع استمرار هذا الاحتلال في بورصة الأكلاف المتصاعدة في حال نهضت المقاومة الشعبية الفلسطينية في مواجهته.
إذا استمر هذا الأداء المبني على الخيارات الضيقة في مواجهة الاحتلال..فإن الحالة الفلسطينية برمتها ومعها العمل الوطني والحقوق المستلبة..ستبقى خارج دواعي القلق والتحسب من قبل الاحتلال..وربما سيأتي وقت لا تأتي فيه الحكومة الإسرائيلية على ذكر الموضوع الفلسطيني إلا من زاوية بروتوكولية في حال تم التطرق للموضوع من أطراف أخرى.