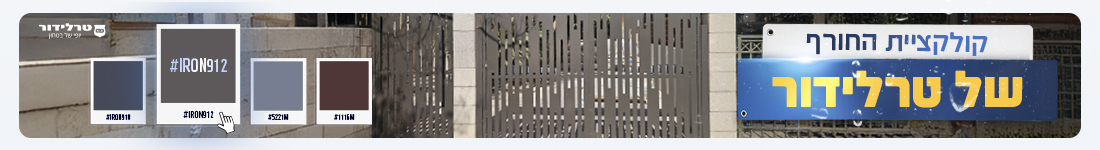أيها الأزهري، يا سارق النار
ويا كاسرا حدود الثـواني
عد إلينا، فإن عصرك عصر
عصر ذهبي ونحن عصر ثان
ارمِ نظارتيك ما أنت أعمى
إنما نحن جوقة العميان
سقط الفكر في النفاق السيـاسي
وصار الأديب كالبهلـوان
يتعاطى التبخير، يحترف الرقص
ويدعو بالنصر للسلطان
(نزار قباني في رثاء طه حسين)
****
احتل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (1889 ـ 1973) مركز الصدارة في العالم العربي في القرن العشرين، فقد كان بحق مالئ الدنيا وشاغل الناس. ويرجع ذلك لأسباب عدة لعل أهمها انه هتك حجب الممنوع وأشرف على مساحات في الوعي العربي ظلت من المسلمات أو المسكوت عنها تحت هيمنة السلطتين السياسية والدينية، وهما تسوغان ما يحفظ مصالحهما البحتة، إضافة إلى قدرة لا حدود لها على المواجهة والمناورة بأسلوب ساحر مشوق يجمع بين عمق الفكرة ونصاعة البيان وقدرة على حشد الأشياع والمريدين.
لقد كان العميد سليلا شرعيا للشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (1801 ـ 1873) الشيخ الأزهري الآخر الذي بث بتعبير الدكتور لويس عوض (1914 ـ 1990) أقوى لغم من ألغام الديمقراطية الليبرالية في مصر أولا وفي العالم العربي ثانيا فقد كانت مصر السباقة إلى كل جديد.
ولا شك أن الدكتور طه حسين قد وجد المناخ مهيأ لاحتضان الفكر الجديد، فكر التنوير والحداثة التي تعني فتح المجال أمام العقل الإنساني للمغامرة والبحث والاكتشاف بحرية وغني عن البيان أن الحداثة في صميمها إنسانية المنطلق والمنتهى.
وما كان أشد حاجة العالم العربي إلى ثورة فكرية وإعصار شامل يجتث جذور التقليد! ويحسب لمحمد علي باشا (1769 ـ 1849) والي مصر طموحه النهضوي وإدراكه أن الاحتكاك بأوربا والأخذ عنها عن طريق البعثات العلمية التي تدرس العلم والأدب وتترجم روائع الفكر وتنقل فنون التمدن سوف يجعل ذلك من مصر بلدا متطورا يسير في طريق التقدم ويبشر بميلاد جيل جديد لا يتنكر للماضي ولا يسرف في تمجيده ولا يغض الطرف عن إنجازات الحاضر في مضمار الثقافة والعلوم والتمدن في الغرب.
وقد كان من رواد ذلك الجيل الشيخ حسن العطار (1766 ـ 1834) شيخ الطهطاوي الذي اقترحه إماما للبعثة التي أرسلها محمد علي للدراسة في فرنسا، ثم علي مبارك (1823 ـ 1893) صاحب الخطط التوفيقية الذي أعاد تنظيم القاهرة الحديثة فشق ميادينها وشوارعها الفسيحة تماما كما فعل البارون هوسمان في تنظيم وتنسيق باريس الحديثة، وخير الدين التونسي (1810 ـ 1890) وغيرهم.
ثم أنه من الخطأ الفادح اعتبار الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 شرا مستطيرا، حقا لقد كان نابليون بونابرت يهدف فيما يهدف إليه زيادة على الأمجاد العسكرية وضع اليد على التراث المصري، وفي صميم ذلك الحضارة الفرعونية المغلفة بحجب الأسرار وما يمكن أن تضيفه كنوزها إلى متاحف فرنسا ودور العلم فيها، ويمكن الآن أن نفهم الدور الذي لعبه العالم شامبليون (1790 ـ 1832) حين فك رموز اللغة المصرية القديمة ومكّن الإنسانية جمعاء من قراءة وفهم الحضارة المصرية القديمة.
لقد كشفت هذه الحملة للعالم العربي عمق الهوة الفاصلة بين الشرق والغرب، الشرق النائم والخانع، المسلوب الإرادة والمقلد، المغمض عينيه عن عجائب الطبيعة المكنونة والحارم خلاياه من التجدد في رحاب الطبيعة والزمان. الشرق الذي أعطى عمره الفاني للميتافيزيقا والذي اختزل العلم في الجانب الفقهي البحت حتى انتهت إليه القدرة في استنسال الكلام من الكلام في شكل متون وحواشي وتعليقات، وقد كانت حلقة الأزهريين في ذلك الوقت تتساءل عن اسم نابليون أهو معرب أم مبني؟
وشجعه الاستبداد السياسي والانصراف عن الطبيعة – الفانية – إلى الولوع بالتصوف كصيغة نهائية لتطليق الزمان والمكان، عوض الاندغام فيهما، وفي الجهة المقابلة يتطاول المارد الغربي – عاصب الغيم على المفرق – في صحة وشباب وقد نفض غبار القرون الوسطى عن عينيه مقتحما السماوات والأرضين باحثا ومنقبا ومروضا عنفوان الطبيعة، محققا الصيغة الإنسانية للحضارة بعد أن عاش أحقابا طويلة في سراديب النص المقدس التي نفاه إليها رجال الإكليروس.
ولقد سجل الشيخ عبدالرحمن الجبرتي (1754ـ 1822) راوية النهضة والشاهد على وقائع الحملة الفرنسية عن جرأة العادات الاجتماعية الغربية والنساء الفرنسيات الساخرات المنطلقات في الشوارع وتحدث عن المسرح والمطابع والتجارب الكيميائية العجيبة.
وهاهو العميد يسجل بقلمه السلس وأسلوبه الرائع مظاهر الجمود والتخلف في رائعته “الأيام” والتي تكتسي أهمية عظمى في توثيق الحياة الاجتماعية والسياسية لمصر في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وإذا كان الطهطاوي قد سجل مشاهدات وانطباعات شرقي يعيش في باريس في الثلث الأول من القرن التاسع عشر في “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”، سوف يصبح ذلك الكتاب ضياء تنبلج به الأصباح وجسرا للتواصل الحميم بين الشرق والغرب، تماما كما سوف تصبح سيرة طه حسين الذاتية جزءها الثاني.
لا مرية أن عميد الأدب العربي مدين في مشواره العلمي لمبادرة محمد علي باشا ولبعثاته العلمية التي أثمرت في النهاية الجامعة المصرية الحديثة يعلم فيها المستشرقون ولفيف من أبناء مصر الذين تعلموا في أوروبا تعليما حديثا كأحمد لطفي السيد مترجم فن الشعر لأرسطو إلى اللغة العربية والذي اكتشف مواهب طه حسين وطموحه فيسر له بعد ذلك السفر إلى فرنسا للاستزادة من العلم وتوجت تلك الجهود بشهادة الدكتوراه عن الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون.
إن قارئ “الأيام” لا شك تأخذه تلك الأجواء الحزينة والتي برع الكاتب في رسم أجوائها الحزينة في قريته عزبة الكيلو في إقليم المنيا في صعيد مصر، وهي أجواء كانت تميز كل الأقاليم العربية، فالأسرة كثيرة العدد والفقر مدقع والدخل محدود والمرأة ملفوفة في وشاح الجهالة صامتة كأنها جلمود صخر، وقد نظر لصمتها بمراسيم فقهية وأفظع من ذلك الحلاق الذي يمتهن التطبيب فيذهب بنور العينين إلى الأبد.
ولعل المنطلق في التغيير هو التعليم، ولعل الداء في التعليم أيضا. إن التعليم غير الصحيح، غير المنسجم مع الواقع وتغيراته والذي يكتفي من الإرث الإنساني ومن الكون برمته بالمتون حفظا واستظهارا وبالشروح والحواشي والتعليقات دراسة سينتهي بصاحبه إلى شل قدراته العقلية وإبادة كل مظاهر الحيوية والديناميكية في خلاياه لينتهي جثة محنطة تدعي الحياة وما هي بحية.
ولا عجب أن يجد الشاب الأزهري طه حسين مللا وفتورا وهو يتردد على حلقات الشيوخ الأزهريين، وسينتهي به المطاف إلى التمرد ثم الثورة على العلم الأزهري والحملة الشعواء عليه في عبارته الشهيرة “لا بد من هدم قرطاجنة”.
لقد تنسم الفتى نسائم جديدة في الجامعة المصرية وسمع بآداب ما أتيح له أن يسمع بها من قبل وبعلوم لا يعرفها الأزهريون قط، وكلها توسع الأفق وتهذب الذوق وتفتح العقل على ثمار الحضارة وسوف ينقل جرثومة النماء إلى الجامعة معلما أدبا ليس كما عرفه السلف على أنه الأخذ من كل شيء بطرف، وأن أصوله بيان الجاحظ وأمالي القالي وأدب ابن قتيبة وخزانة البغدادي، ولكن من حيث كونه إنتاجا عاكسا للتاريخ في صيرورته وللبيئة ومعطياتها المتغيرة ملقيا على مسامع الطلبة أسماء جديدة كتين وبوالو وغيرهما.
وإذا كان الشك طريقا إلى اليقين فما أحوجنا – نحن العرب – إلى هذا المبدأ. إن إعجاب طه حسين بأبي العلاء ليس لاشتراكهما في آفة واحدة، ولكن لأن أبا العلاء عبر في لزومياته عن مبدأ الشك هذا قبل ديكارت، وأمعن فكره الثاقب في الثابت والمتحول وفي عالم الغيب وعالم الشهادة:
في اللاذقية قتنة
ما بين أحمد والمسيح
هذا بناقوس يدقــ
ق، وذا بمئذنة يصيح
كل يعزز دينه
ليت شعري ما الصحيح؟
وهو يؤكد على حقيقة الشك الذي هو طريق إلى اليقين حين يقول:
أثبت لي خالقا حكيما ** ولست من معشر نفاة
ونحن في مسيس الحاجة إلى أن نشك في تراثنا الشعري القديم في غياب التدوين وانتشار الأمية في ذلك الوقت وظهور التنافس السياسي والمطامع الشخصية في الأحزاب السياسية التي دفعت إلى التقول على الشعراء ما لم يقولوه دفعا لضرر أو جلبا لمصلحة وحتى الحديث النبوي لم يسلم من ذلك فما أكثر ما تقول الناس على الرسول الكريم ما لم يقله!
ثم إن التسليم بأن ذلك التراث الشعري صحيح برمته ضرب من الخبل ومجافاة لحقائق التاريخ ومنطق العلم، ومن المغالاة في الخطأ تقديس ما تناول بالشرح النص المقدس، إذ أنه جهد بشري في فهم النص يحتمل الخطأ أو جزء منه، أو يحتمل الصواب أو نصيبا منه.
لقد سبب ذلك تخلف العالم العربي، فالجوهر الذي يحتل حيزا ضيقا حين تمظهر في الفهم والممارسة صار بلا حدود وما المظهر إلا الفهم والممارسة لكنهما اكتسيا طابع المعيارية والإطلاق والسرمدية، وبذلك انتفىت مبادئ الاختلاف والتعددية والنسبية وقضية المرأة أحد التجليات لهذه المعضلة التي قصمت ظهور الأوائل والأواخر.
لقد كان طه حسين مدركا لنشر كتاب عن الشعر الجاهلي في ظل وجود سلطة دينية وصية على النص لها شرعيتها التاريخية في اللاوعي الجمعي المقهور والذي يعني رهابا وفصاما وهي يمكنها بجرة قلم تكفير رأي أو إهدار دم ولكن لا مفر من نشر الوعي وبذر بذور الفكر العلمي واحتمال الأذى بصبر وأناة، ولقد كانت تجربة مريرة أن يعزل الكاتب من منصبه ويحاصر في بيته، ويعير بعاهته ونظرا لقوة التحالف القائم بين السلطتين السياسية والدينية وإدراكهما للخطر المحدق بهما نتيجة بذر بذور التجديد والتغيير والاختلاف والشك الذي هو طريق إلى اليقين اضطر الكاتب إلى حذف فقرات أسخطت الساخطين عليه وهيجت المتظاهرين ولكن لا تراجع عن الكتاب وعن مبدأ الشك .
وكأن الكاتب يقدم مثلا للمناورة حين يقول الكاتب لا وهو يريد نعم، وحين يتظاهر بالعدول عن موقفه – لا جبنا – ولكن حفاظا على الحياة لمزيد من العطاء والمقارعة، ولقد اضطر جاليليو إلى التظاهر بالعدول عن فكرته في القول بدوران الأرض أمام محكمة التفتيش حفاظا على حياته وعلى استمرار البحث وأوصى كوبرنيكوس بنشر كتابه عن الهليوسنترزم “مركزية الشمس” بعد وفاته أما جيوردانو برونو فالحرن على أفكاره قاده إلى الموت حرقا وهو نفس الخطأ الذي ارتكبه سقراط لما جاءه تلاميذه يعرضون عليه الهرب، فأبى مكتفيا بالقول إن القانون الذي حماه بالأمس مواطنا يحمه هو اليوم مذنبا.
ترى لو لم يفعل ذلك طه حسين أكان علي عبدالرازق يجرؤ على نشر كتاب “الإسلام وأصول الحكم”، وزكي نجيب محمود “المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري”، وحسين أحمد أمين “دليل المسلم الحزين”، وصولا إلى محمد أركون، الطيب تيزيني، وعبدالله العروي وبرهان غليون وغيرهم.
وحين تولى طه حسين وزارة التعليم أعطى المثل حين يمارس المثقف قناعاته ونضاله الفكري والتنويري، فقد دافع عن مجانية التعليم مطلقا عبارته الشهيرة “التعليم كالماء والهواء” أي مجاني مما جعل خصومه – وما أكثرهم – يطلقون عليه لقب “وزير الماء والهواء!”.
ولقد خاض الكاتب الكبير معارك ضارية مدافعا عن رسالة التجديد ومبدأ “الأدب للحياة” واكتست تلك المواجهات على صفحات الجرائد السيارة طابع الشراسة – حد الألفاظ النابية – خاصة مع الرافعي – شيخ المحافظين- حتى أن الرافعي تهكم من طه وكتابه عن الشعر الجاهلي في مقولته الشهيرة: “إسفنجه جاءت لشرب البحر وشمعة تتصدى لشمس الظهر وطه في نقد الشعر” فرد عليه طه حسين بقوله إن الرافعي حين يشرع في الكتابة يقاسي آلام الوضع، إشارة إلى التكلف.
ولا تكتمل رسالة التنوير إلا بمد جسور مع الفكر العالمي في صيغتيه التاريخية والحديثة عبر تعريب روائع الفكر الإنساني ولقد كان المفكر الكبير مدركا لقيمة الفكر والأدب اليونانيين فعرف القارئ العربي بهما في نظام الأثينيين ومسرحيات سوفوكليس، وأما الحديثة فترجمات لمسرحيات فرنسية ذائعة. فلا مستقبل لأمة تغمض عينيها عن ثمرات الفكر والأدب وسوف يعود إلى تأكيد هذا المبدأ في “مستقبل الثقافة في مصر”: هو أن نأخذ من الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب”، وسوف يؤكد على بعدين أساسيين في نهضة مصر الحديثة أولهما البعد الفرعوني وثانيهما المتوسطي، فمصر تشرف على البحر الأبيض وتربطها بأوروبا وشائج من القرابة التجارية والفكرية والجغرافية أو لم يتجسد هذا التقارب في عصر البطالسة حين كانت الإسكندرية قطب العالم المتنور المتحضر المبدع؟
لكن طه حسين لم يقبل قط بفك الرابطة مع العالم العربي وهو رئيس مجمع اللغة العربية، وسفير العالم العربي إلى الإنسانية قاطبة، ليس في دعوته غلو كما في دعوة سلامة موسى بالأمس، وأحمد رجب اليوم حين يدعو إلى جمهورية مصر الفرعونية مجافيا منطق التاريخ والجغرافيا معا، ولا كان متنصلا من قيم الإسلام، وقد كتب روائع لعل أهما “على هامش السيرة، ومرآة الإسلام، والفتنة الكبرى، والوعد الحق والشيخان”.
ولا يكتمل التنوير الفكري بغير تنوير سياسي، ولقد انخرط الكاتب في حزب الأحرار الدستوريين الذي أسسه عدلي يكن، ويمكن القول إن تأثير فكر الثورة الفرنسية ومبادئ حقوق الإنسان التي سيطرت على عقول منخرطيه، وقد نور الطهطاوي عقول مثقفي ذلك العصر بترجمة القانون الدستوري الذي نشره جيزو وزير التعليم في حكومة الملك لويس فليب وأهما الترويج للفلسفة السياسية التي كان يستند إليها ومن ركائزها صيانة الحقوق والحريات الفردية وإقامة نظام نيابي برلماني حر وصيانة الحرية في الحياة الشخصية والاعتقاد والاختلاف والتعبير عن الرأي بكل الطرق الممكنة ومن ضمنها حرية الملكية التي لا تقل احتراما عن حرية التفكير التي تصونها السلطة القضائية والعدل الذي هو أساس العمران والشورى اللازمة للحاكم وتدبير الدولة الحديثة.
وأخيرا ماذا يبقى من طه حسين للقرن الواحد والعشرين وللمستقبل العربي؟
من المؤسف أن الأمة العربية تسجل راجعا في التبشير بفلسفة الأنوار والسعي إلى دولتها والعيش في حماها، وكأن هذا العصر الرقمي زاد من سذاجتنا وغفلتنا فازددنا تعلقا بالقشور على حساب اللباب وبالرماد على حساب الوهج ، وبالأمس على حساب اليوم وبالحزن على حساب الفرح وانظر إلى قضية المرأة كأنها لم تبرح مكانها منذ كتابات قاسم أمين واليوم يطلع علينا من يفتي بأن صوتها عورة ناهيك عن كشف وجهها وخوضها في شؤون الفكر ومعترك السياسة وانظر إلى قضية الاستبداد تجدها معضلة المعضلات لم تجد نهايتها في طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد للكواكبي واليوم يحف بالحاكم لفيف من أدعياء الفكر يسبحون بحمده بكرة وعشيا، فيزيدون من تخلف القطعان البشرية. وأين العلم الذي بشر به فرح أنطوان وشبلي شميل ويعقوب صروف، فما عاد إلا علم الإعجاز القرآني، وكلما طلع علينا الغرب بنظرية قلنا لها سوابق في الكتاب الكريم!
إن الواقع العربي المتردي يفرض اليوم تنويرا جديدا بل ثورة فكرية تغير واقعنا وتتجاوز المحاولات التأسيسية للرواد بمن فيهم طه حسين نفسه.
إن هذه الطفرة التنويرية هي من قبل الثورة التي دعا إليها الدكتور حسن حنفي في “قراءة عربية للنهضة الأوربية: “أما عصر النهضة العربية فقد آثر قراءة انتقائية للنهضة الأوروبية تتفق مع الموروث القديم دون أن تتخلص منه واكتفى بالتلميع للقديم نفضا للتراب والصدأ عنه، وكان أقصى طموح للإصلاح الملكية المقيدة بالدستور دون تقويض جذري للنظم الثيوقراطية والإقطاعية والملكية بالرغم من ثورات العرب الحديثة وكتاباتهم في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ظل الإيمان بالقديم قائما وكل من شك فيه تم تكفيره حتى ولو كان في الشعر العربي وقضية الانتحال أو في الحوامل الزمانية والمكانية واللغوية والإنسانية للوحي في فهم النص الديني استدراكا على أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
فما أحوج أمتنا إلى ثورة ثانية تغسل ما بها من درن وركود وتقليد تحت غطاء العلم وخنوع تحت ستار الطاعة، وعزوف عن الحياة بحجة الزهد في الدار الفانية، وجبن عن اقتحام المجاهل حتى الموت حتف الأنف لنشرف على الحياة فنشبع من هوائها ومائها وسمائها ووحلها فقد طال بنا الأمد في مغارات التاريخ وكأننا ما بقي متحجرا من كائناتها البائدة.