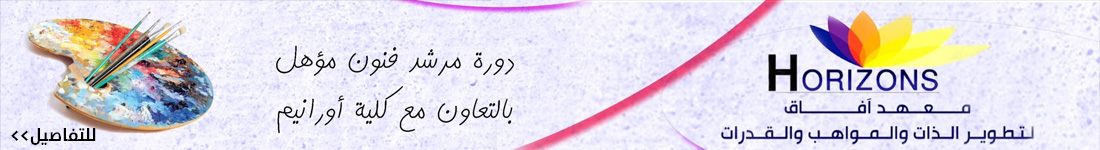الطرف الذي تصرف على الأرض منذ فترة مبكرة على أن «النظام سقط»، لم يكن واشنطن ولا «أصدقاء الشعب السوري». كما أن هذا الطرف لم يكن الكرملين، إذ إن أميركا وروسيا اتفقتا منذ منتصف ٢٠١٢ على «مرحلة انتقالية» وهيئة حكم من المعارضة والموالاة تحافظ على مؤسسات الدولة لمنع تكرار تجربة العراق. لم يفكر الأميركي والروسي جـــدياً في ما وراء مؤسسات النظام. كانت موسكو تستخدم الملف السوري لضبط خساراتها في الشرق الأوسط بعد العراق وليبيا وتحسين موقعها الدولي، فيما كانت واشنطن لا تريد الفوضى الكـــاملة في ما تبقى من سورية وتضـــغط كي يتخلى النظام عن ملفاته الرئيسية، خصوصاً الترسانة الكيماوية، ثم لاحقاً عدم ممانعة متابعة الجهاديين الذين يقاتلون «حزب الله» على الأرض السورية لعشر لسنوات أخرى، والضغط على إيران في المفاوضات النووية، طالما أن الأزمة السورية «محتواة ضمن الحدود».
المشروع الإيراني كان في مكان آخر. استراتيجية طهران كانت أيضاً في مسار آخر. بعد اندلاع «الربيع العربي» ووصول رياحه إلى دمشق، وضعت إيران كل إمكاناتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، لمنع وصول عدوى الميادين إلى سورية بدءاً من «ساحة الساعة» في حمص وسط البلاد، لكنها كانت تدرك أن النظام انتهى بنيوياً، ولا بد من نظام جديد وجغرافيا جديدة وعقد اجتماعي جديد بين النظام والجغرافيا والديموغرافيا.
كانت الرؤية واضحة والأدوات موجودة. وعاد كل حلفائها في العراق وسورية ولبنان إلى الوظيفة التقليدية في المشروع الإيراني. انخراط من دون قفازات. راحت إيران تعمل بهدوء لتأسيس «نظام ظل» يتضمن الكثير من المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولعل إحدى الأدوات الرئيسية تلك الميليشيات البعيدة من سلطة المركز كما هي الحال في دول أخرى. نسخ الحرس الثوري الإيراني تجربة «الباسيج»، وأسس «قوات الدفاع الوطني» لتكون تحت تأثير إيراني مباشر عبر تدريبها في إيران وتقديم التمويل ووجود مرشدين في مناطق سوريّة عدة. ويُعتقد أن عدد مقاتلي «قوات الدفاع» يبلغ حوالى مئة ألف مقاتل.
واللافت أن غالبية أفرادها من السنّة المهمّشين والعاطلين من العمل الذين تحـــولوا في فترة قصيرة وهم في مقتبل العمر، إلى أصحاب نفوذ وسلطة وأموال عبر منح رواتب عالية وأسلحة ولباس عسكري موحد. دورهم هـــو ضبط المجتمع المحلي وأن يكونوا مصدّاً في مواجهة مــــقاتلي المعارضة وعيوناً للتجسس على المجتمعات النائية.
وفي كثير من الأحوال، فإن هؤلاء لا يدينون بالولاء للسلطة المركزية في دمشق. ويُحكى عن تجارب عدة من أن «توجيهاً» صدر من جهات عليا في العاصمة لإزالة حاجز في منطقة في وسط البلاد، لكن المسؤول عن الحاجز رفض تنفيذ الأوامر. ويُحكى أن المفاوضات الجارية لعقد اتفاق دائم للتهدئة في حي الوعر بحمص وسط البلاد، غالباً ما كانت تنفجر لأن مسؤولين في «الدفاع الوطني» وفي أحياء شيعية لم يكونوا راضين عن الاتـــفاق. كما تنقل روايات أن قادة محليين لـ «الدفاع الوطني» باتوا يدينون بالولاء لقائدهم العام فادي صقر والمصدر الرئيسي للمال والسلاح أكثر من ولائهم لوزير الدفاع أو الحكومة.
اللجوء إلى «الدفاع الوطني» كان لتعويض الخسائر التي مُني بها الجيش النظامي، إذ تتحدث مصادر عن مقتل أكثر من مئة ألف عنصر وضابط وفق قيود شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع، إضافة إلى تراجع حاد في عدد المجندين إلى بضعة آلاف في كل ستة أشهر بعدما كان العدد يتجاوز ٦٠ ألفاً قبل ٢٠١١، وحصول انشقاقات كبيرة في مناطق سنّية وتهرُّب شباب مناطق الساحل من الخدمة إلى المهجر. كل ذلك أدى إلى تقلُّص عدد الجيش النظامي إلى حوالى مئة ألف مجنّد. قوبل ذلك بفرض قيود على تطبيق الاحتياط ومنع سفر شرائح واسعة من الشباب على البوابات الحدودية ووقف خطوط نقل بحري كان يستخدمها أبناء الساحل.
إضافة إلى ذلك، سعت إيران إلى توسيع شرائها العقارات وتوسيع المزارات الشيعية في دمشق وحمص وتسهيل ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال الذين استفادوا من العمولات الناتجة من التحايل على العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة، خصوصاً في مجالي قطاع النفط والطاقة والمواد الغذائية. كما وضع «أمراء الحرب» أعينهم على المخططات الجديدة لإعادة إعمار المناطق المدمّرة في العاصمة، لمزج المكاسب المالية بتغييرات في ديموغرافيا العاصمة تضاف إلى «حزام الفقر» الذي زنّر دمشق في العقود السابقة ولعب دوراً رئيسياً في السنوات الأربع سواء في المرحلة السلمية أم العسكرية.
وليست مصادفة أن الديموغرافيا لعبت دوراً حاسماً في طبيعة التهدئات الحاصلة في دمشق بين «توازن» حيَّيْ عش الورور الموالي وبرزة البلد المعارض شمال العاصمة و «عدم توازن» اتفاق السومرية المعسكر ومعضمية الشام ومجلسها المحلي في جنوبها الغربي. وباعتبار أن إيران تدرك جيداً الديموغرافيا والتاريخ، فتحت أقنية لتوسيع نفوذ رجال أعمال ودين سنّة عبر تقديم تسهيلات مالية وهوامش للنفوذ.
وضوح إيراني
جديد إيران، إقدامها على إعلان قيادة الملف العسكري على الأرض. لم يكن خافياً دور «الحرس الثوري الإيراني» ولا دور الميليشيات العراقية والآسيوية ولا دور «حزب الله» في الصراع المسلح منذ نهاية ٢٠١٢. لكن طهران قررت إعلان دورها بوضوح في المعارك. بداية في معارك ريف حلب شمالاً، ثم في «معركة الجنوب» في مثلث دمشق ودرعا والقنيطرة قرب الجولان المحتل من إسرائيل والأردن بوابة الخليج.
أغلب الظن أن إيران تحاول أن ترث النظام السوري في سورية كما سبق أن ورثته في لبنان. اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري وفرض عزلة على دمشق، ثم خروج الجيش وقوات الأمن من لبنان في 2005، أمور أنهت حقبة من الوجود السوري في لبنان. هذا الوجود كان ضمن «قواعد لعبة» فرضت منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية وصولاً إلى اتفاق الطائف. دخول سورية كان بضوء أخضر أميركي – روسي في النصف الثاني من السبعينات أُعطي إلى الرئيس حافظ الأسد. انتقل الوجود إلى مرحلة ثانية باتفاق الطائف بتفاهم إقليمي مع السعودية مستفيداً من انتهاء الحرب الباردة. كما استفاد الأسد من الدخول في عملية السلام و «عاصفة الصحراء» للقضاء على الجنرال ميشال عون والسيطرة على القرار اللبناني لأكثر من عقدين. أيضاً، تضمّن الوجود السوري تفاهماً حول «الخطوط الحمر» حول طبيعة الأسلحة التي يمكن أن تنتشر في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل.
خرجت سورية من لبنان. وفقدت قيادتها وشراكتها في إدارة لبنان. وفي السنتين الماضيتين، كان لدور «حزب الله» وإيران الحصة الأكبر في إنقاذ النظام. وها هي إيران، تحاول طرح معادلة في سورية شبيهة بالمعادلة التي طرحتها سورية في لبنان. تحاول الإفادة من الحرب على الإرهاب وتسهيل مهمة التحالف الدولي – العربي ضد «داعش» والمفاوضات النووية، كي تعرُض الصفقة الآتية: أمن إسرائيل والخليج مقابل السيطرة على القرار في بلاد الشام وفي العراق، بحيث يترك لها ملف إدارة السياسة بما يراعي مصالح الغرب والخليج. في قيادتها «معركة الجنوب» تفتح ملفاً تفاوضياً كانت خسرته بعد صدور القرار ١٧٠١ بعد حرب عام ٢٠٠٦. تعرض نفسها شريكاً عقلانياً يعرف قواعد اللعبة في «سورية المفيدة» بدل جنون «جبهة النصرة» والفصائل المعارضة. تعرض نفسها ضامنة لاتفاق فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل لعام 1974، وإعادة «القوات الدولية لفك الاشتباك» (أوندوف). تعرض نفسها أيضاً سداً منيعاً أمام تقدم «داعش» إلى الأردن، ثم إلى الخليج.
لا يُقلق هذا العرض إدارة الرئيس باراك أوباما. واشنطن مستعدة للتفاوض عليه. ودعمها «المعارضة المعتدلة» السورية ضمن جهود التفاوض مع إيران عبر «نزفها» وجلبها إلى طاولة التفاوض. لكن العرض الإيراني، مقلق أكثر لفلاديمير بوتين. روسيا كانت منذ بداية الأزمة توفر الغطاء والحماية للنظام في مجلس الأمن عبر حق النقض (فيتو) المدعوم من الصين. كانت أيضاً، تقدم الدعم العسكري والمالي إلى مؤسسات الدولة السورية. موسكو ترى نفوذها تاريخياً في المؤسسات التقليدية، خصوصاً الجيش والأمن. طهران ترى نفوذها في المؤسسات غير الحكومية. روسيا تؤمن بحل «من فوق إلى تحت» عبر تفسيرها لـ«بيان جنيف» والهيئة الانتقالية. إيران تؤمن بحل «من تحت إلى فوق» من بوابة اقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لأنه يعطي دوراً أكبر للقادة المحليين والميليشيات.
المؤشرات الآتية من موسكو، تدل على قلق روسي من النيات الإيرانية. بعثت روسيا أكثر من رسالة غامضة، عبر تبنّي قرارات دولية بينها التخلي عن الترسانة الكيماوية ٢١١٨، وقرارات المساعدات الإنسانية بما فيها «العابرة للحدود»، ثم قرار منظمة حظر السلاح الكيماوي لرفع ملف استخدام الكلور إلى مجلس الأمن، ذلك بعد موافقتها على بيان جنيف في ٢٠١٢ ومشاركتها في المؤتمر الدولي في بداية العام الماضي. لكن هناك حدوداً لمدى التعاون الأميركي – الروسي بسبب تجدد «الحرب الباردة» في شكل أكثر برودة بين الطرفين والأزمة الحادة في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو وحديث بوتين عن نيات غربية لـ«تغيير النظام» الروسي.
قلق روسي
من يلتقي المسؤولين الروس، يعرف أن موسكو قلقة من صفقة أميركية – إيرانية. قلقة من أن يفوتها القطار. قلقة من أن أميركا منغمسة في مناطق سورية الخارجة عن سيطرة النظام بغارات مقاتلات التحالف الدولي – العربي ضد «داعش» وببرنامجي تدريب المعارضة السري والعلني. في موسكو، بحث عن حل في «سورية المفيدة» بحيث تكون هي راعية ما تبقى من مؤسسات الدولة وتوفير الأمن لإسرائيل والخليج. ولا غرابة في استضافة روسيا الحوار السوري – السوري على تواضع التوقعات منه. ولا غرابة في إجرائها اتصالات سرية مع مسؤولين سوريين سابقين بحثاً عن خيارات.
سورية هذه «مفيدة» إستراتيجياً، فهي تمتد من درعا قرب الأردن والجولان قرب إسرائيل جنوباً وتتمركز في العاصمة وتمر بحمص في الوسط قرب مناطق نفوذ «حزب الله» في لبنان، وصولاً إلى طرطوس واللاذقية في الساحل حيث تملك روسيا موطئ قدم على البحر المتوسط.
روسيا قـلقة من خــسارة ســوريـــة لمصلحة طهران، كما خسرت العراق. وهناك صراع روسي – إيراني على ما تبقى من «سورية المفيدة».
* صحافي سوري من أسرة «الحياة»