
مشهد حلق الشوارب من قِبل فئة لا تقيم وزناً لأي أخلاق ولا لأي قيم ولا لأي كرامة، يجب أن يكون مداناً بأشد العبارات وأوضحها.
على نافذة الغرفة رقم 18 في الطابق الأول من المبنى رقم 40 في المدينة الطلابية في العاصمة البلغارية صوفيا، كنت أقف كل صباح لأطعم الحمام في الساحة الملاصقة للمبنى. أفتفت الخبز وأنثره على حافة النافذة وعلى العشب القريب، فيأتي الحمام عن أسطح المباني المجاورة ويحط تحت نافذتي. يوم بعد آخر على هذه العادة صار لدي المئات من طيور الحمام، والتي تتجمع في المكان حتى قبل أن أفتح النافذة.
في صباح يوم من أيام الأحد، وهو العطلة الرسمية للجامعة كما لبقية المؤسسات، سمعت طرقاً على باب الغرفة، ففتحت. كان شاباً من جيلي أو أكبر قليلاً، فبادرني بعد صباح الخير بأن عرّف عن نفسه ” أنا بهاء بو كرّوم من لبنان، أسكن في الغرفة المجاورة، هل تسمح لي بأن أشاركك هذه الهواية للحظات؟” عرضت عليه سيجارة فقال إنه لا يدخن، ثم عرضت فنجاناً من القهوة فقال إنه لا يشربها، فسألته ماذا يشرب إذن؟ فأجاب: أشرب المتة، وسأدعوك لتشربها معي.
كانت هذه الحادثة في العام 1985، ويومها فقط، وبعد ساعة من الحديث، عرفت أن ثمة طائفة يُطلق عليها “بنو معروف” وثمة مشروب يُطلق عليه “المتة”، وثمة “قاف” تُنطق بكامل أبّهتها، وثمة طعام يُدعى “الكشك”، وثمة عامر سيُنادى فيما بعد من قِبل أصدقائه الفلسطينيين بـ “الدرزي”، لعلاقاته الوطيدة مع شباب هذه الطائفة في لبنان وسوريا.
لقد عرّفني بهاء على أصدقائه الدروز من جبل لبنان، على أجود عبد الخالق ووسام القاضي وشوقي عمار والكثير غيرهم، فصرت زائراً متردداً وضيفاً افتراضياً دائماً في عين عنوب والمختارة وبعقلين وكفر متى ومزرعة الشوف، أعرفها كما أعرف قريتي في فلسطين، وصرت أتمشى في محمية أرز الشوف وألتزم بالقانون كما يلتزم الحارس هناك، بألا أرمي قمع سيجارة على الأرض، وبألا أزعج السناجب على جذوع الأشجار، وبأن أتحدث بالقاف المفخمة مع أي سائح يصادفني، وكأنني ابن المكان الذي لا يريد خدش صورته.
كان شوقي عمار شاعراً ينظم الزجل، وهو ابن عين عنوب، بلدة الشاعر الكبير طليع حمدان، وجاره وأحد محبيه الكثر. فلأجل طليع حمدان وبسببه كان من الصعب أن تجد درزياً لا يحب الشعر أو لا يحاول كتابته، أما ما يميز شوقي فهو أنه كان شاعراً لا يقل أهمية عن طليع، وما التقدير العالي الذي يكنه لابن بلده إلا بحكم احترامه للتجربة الأطول والعمر الأكبر.
صار شوقي يهديني كل ما تقع عليه يده من كتب، أو كاسيتات تحتوي على الزجل اللبناني، ثم صار يهديني كتبه هو، ثم انتقل إلى مرحلة التحدي لي، بأن يهجوني ببيتين أو قصيدة كاملة ويعطيني الوقت الكافي للرد؛ خذ وقتك. هكذا كان يقول، لكنني أريد رداً ذكياً وجميلاً. وصرت أحاول وأحاول، أنجح مرة وأفشل مرات، إلى أن صرت أجيد الزجل اللبناني دون مشقة كبيرة، بل وأقوله ارتجالاً دون تحضير مسبق.
انتهت سنوات الدراسة والزجل وعدت إلى فلسطين، وكان هدفي الأول هو ان أحوّل هذا المخزون من المعرفة “الزجلية” إن جازت التسمية، إلى شعر باللهجة الفلسطينية المحكية، وأظنني نجحت، فقد نال ديواني الأول بعض الجوائز المهمة ورضا الكثير من النقاد، ولأن همي كان أن أنال رضا معلمي شوقي، فقد أرسلت له مخطوطة الكتاب قبل الطباعة، ولكم كانت مفاجأتي كبيرة حين طلب مني أن يكتب هو المقدمة، والتي ورد فيها:
الشاعر إجا من عند الله فرضْ
تَ يكون كِلمِة هالدني كِلّا
صلّوا ما يبكي شاعر على الأرضْ
بيتخربش البيكار مع الله.
في فلسطين، وبعد سنوات قليلة من تخرجي صرت عضواً في اللجنة الاجتماعية لنقابة أطباء الأسنان، فقمت مع زملاء لي بترتيب زيارة إلى الجولان السوري المحتل، للقاء زملائنا هناك. كان ذلك في موسم التفاح الذي تشتهر به هضبة الجولان، فقررت أن آخذ ابنتي داليا، ذات الأربع سنوات، معي. بعد أن قمنا بجولة في قرية مجدل شمس، أخذنا زملاؤنا إلى مزارع التفاح الخاصة بهم، وصاروا يعطون كل طبيب صندوقاً ويأمرونه بأن يقطف ما يريد.
لم آخذ الصندوق المخصص لي، ولم أكن جزءاً من كرم أهل الجولان وطمع أهل رام الله، بل بدأت بالتمشي بين أشجار التفاح أنا وابنتي، والتي كانت تحتفل برؤية تفاحة خضراء، وترقص لرؤية تفاحة حمراء، وتغني وهي تبتسم في غاية السعادة: بابا كتيير تفاح.
فجأة، تقدم باتجاهنا أحد الزملاء وسألني وهو يعرّف بنفسه: أنا د. مجيد صفدي، وهذه المزرعة لي، فلماذا لا تقطف مثل البقية؟ قلت: أنا أحب النظر أكثر من الأكل. فضحك وقال: لكننا نحب من يأخذ، وعليك أن تأخذ. أجبت: إن كان لا بد من الأخذ، فلا أمانع بكيلو من الكشك أو قنينة من العرق البلدي، أما التفاح فأفضّل أن أتركه على أمه الشجرة، إلى أن ينضج وتفرح بقطفه أنت.
هذا الحوار المصحوب بالضحكات الصادقة، وبتقافز داليا بين أرجلنا جعل منا صديقين ستستمر صداقتهما لسنوات طويلة بعد ذلك. صارت الجولان وجهتي الدورية حين أملّ من رام الله، وصارت رام الله وجهة مجيد وزملائه أيضاً. كنا نجلس في مزرعة أحد الزملاء ليلاً، نشرب العرق ونقرأ الشعر، بينما تتساقط قذائف حزب الله وتنفجر تحتنا في سهل الحولة. وكانوا يأتون إلى رام الله منهكين من كثرة الحواجز والطرق الالتفافية، وأسئلة الجنود الكثيرة عن وجهتهم وهدفهم من دخول “المناطق” وهو الاسم الذي يطلقه الجيش على الضفة الغربية.
في سنوات لاحقة اشتغلتْ معي في العيادة طبيبة من مجدل شمس تدعى تمارا، كانت تقيم في رام الله مع زوجها الذي يعمل مصوراً لإحدى المحطات الفضائية، فقررت العمل قريباً من سكناها. كانت تمارا تسافر إلى الجولان مساء الخميس وتعود صباح الأحد إلى رام الله. في يوم من الأيام سردت لها قصتي مع أصدقائي دروز الجولان، وكيف بدأت بسبب صندوق تفاح، فما كان منها إلا أن أحضرت لي صندوقاً مع بداية الأسبوع التالي، ثم الذي يليه، وهكذا. صار لدي كل صباح أحد صندوق من التفاح، حتى عندما تركتْ تمارا العمل في عيادتي ظلت هي وزوجها على هذه العادة، وصرت أعرف أن صندوقاً من التفاح ينتظرني على باب العيادة كل صباح أحد.
بعد سنة تقريباً، قررت أن أفاجئ تمارا وزوجها، وأن أزورهم في بيتهم في مجدل شمس. ركبت سيارتي واتجهت إلى الجولان، وهناك سألت عن عنوانهم فدلني عليه صاحب دكان، لكنني لم أجد أحداً في البيت، وحين سألت الجيران دلوني على مكان مزرعتهم التي يتواجدون فيها أيام العطل الأسبوعية. وصلت وإذا بتمارا تجلس على تلة في المكان وأمامها مجموعة من البقرات، وحين سألتها: هل ترعين البقر؟ أجابت: لا، أنا أرعى مع البقرات.
كانت هذه الإجابة استكمالاً للشعر الذي علمني إياه شوقي، بل كانت شعراً من نوع جديد سيلازمني وسيشكّل لديّ فهماً جديداً لمعنى الأرض والالتصاق بها، بتفاحها وكرزها وأعشابها وزهورها وبقراتها.
لم أتعرف على بهاء ووسام وتمارا ومجيد فقط، بل تعرفت على عائلاتهم أيضاً؛ على المناديل البيضاء لأمهاتهم، وعلى اللحى البيضاء لآبائهم وأجدادهم، على طريقتهم بشرب المتة بالماء أو الحليب، على طبخهم للكشك مع القاورما، على اللبن البقري الحامض على طاولة الإفطار في بيوتهم، وعلى خلواتهم وشيوخهم.
لكل ذلك، وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية، أو انحيازات طائفية، في بلاد لم يعد فيها أي شيء يمكن الإمساك به مطولاً، وبعيداً حتى عن التاريخ بأفضليته والمستقبل بقتامته، فإن مشهد حلق الشوارب من قِبل فئة لا تقيم وزناً لأي أخلاق ولا لأي قيم ولا لأي كرامة، يجب أن يكون مداناً بأشد العبارات وأوضحها. فيا أخوتي الموحدين، العرب، الدروز، بني معروف، الأصدقاء، يا من علمتموني الشعر، أنا أعتذر منكم.
عامر بدران – طبيب وشاعر فلسطيني (عن رصيف 22)



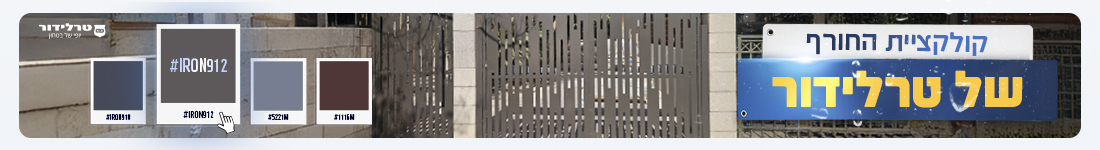






























تحياتي د.عامر
اولا اشكر صدق مشاعرك ولكن للأسف على ما يبدو ان الموضوع اكبر من ذلك بكثير.
ولا ادري كيف اتناول الموضوع من دون جرح مشاعر اخوتي واصدقائي المسلمين وخاصة اولئك الذين درست معهم وسكنت معهم اثناء دراستي في جامعة بيرزيت.
حيث كنت انام معهم في نفس الشقة وتشاطرنا الافراح والحزان وحتى ايام الاعتقال معا.
ولكن هناك ازمة في الدين الاسلامي وتحديدا الاختلاف الشديد بين الايات المكية والايات المدنية.
وعلى ما يبدو ان الشباب المعتدل والواعي لم يقرأ الايات المدنية، خذ مثلا الآية 67 من سورة الانفال:” حتى يثخن في الارض ”
انا اعتذر منك مرة اخرى ومن كل اخوتي واصقائي المسلمين، ولا ادري ما الحل ولكن الحقيقة ان داعش تتصرف وفق تعاليم الدين حتى ان الازهر لم يستطع تكفير داعش.
الموضوع حساس بشكل خطير فويل لي ان اسأت لشعور اصدقائي ومن ناحية اخرى ويل لي ان تابعت غض العين عن امور واضحة لي حتى من ايام الجامعة ومثال صغير على ذلك انه في اي مكان في العالم فقط الشباب المسلم يريد ان يعرف ديانتك حتى من اول لقاء ان كان عمل او رحلة مع ان هذا موضوع شخصي لا يجب ان يكون من شأن الاخرين